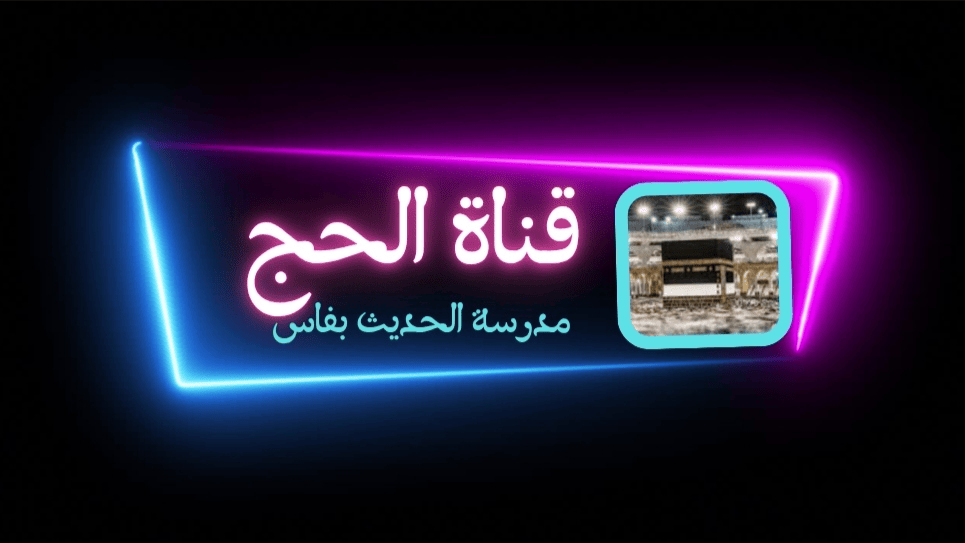ويُقبَلُ الإعلالُ بالإجمالِ
من الإمامِ دونما سؤالِ
لأنه الأَدرَى وإن لم يستطعْ
توضيحَ إعلالِ الحديث فاتَّبِعْ
وقيل عِلمُه بذا إلهـــــــــامُ
يَعرِفُه المحدِّث الإمامُ
لكن إذا خُولِف فالترجيحُ
عليه الاعتمادُ والتنقيـــحُ
ومثله إن لم يرجِّحْ واكتفى
بذكرِهـــــا إشارة وعــــرفَا
(ويُقبل الإعلال)؛ أي الحكم على الحديث بأنه معلول (بالإجمال)؛ أي: إجمالاً دون تفصيلٍ ببيان سبب العلة، من الإمام الذي أعلَّ الحديث (دونما سؤال)، فلا يشترط لقبول إعلاله للحديث توضيحُ سبب العلة، إذا كان الإعلال من الخفاء ما يصعب التعبير عن سببه، وهذا وقع لكثيرٍ من الأئمة الذين أعلُّوا كثيرًا من الأحاديث ولم يبيِّنوا السبب، ليس لأن الإعلال عارٍ عن الحجَّة، ولكن لدقة السبب وغموضه؛ بحيث لا يقوى الإمام الناقد للحديث على التعبير عنه بلفظ؛ لأنه أدرى بعلة الحديث الذي أعله، (وإن لم يستطع توضيح) سبب (إعلال الحديث)؛ إما لقصور فهم مَن سأله عن الفهم في هذا الباب، أو لدقة السبب؛ بحيث يستعصي أحيانًا التعبير عنه، (فاتبع) حكمه على الحديث بالعلة، فكما يقبل منه التصحيح ويُعتمد عليه فيه، يقبلُ أيضًا منه الإعلال، فمدار قَبول هذا وذاك على ثقة الإمام وأهليته للحكم في الحالتين، (وقيل علمه)؛ أي: الإمام (بذا)؛ أي: بهذا العلم، وهو علم العلل (إلهام) من الله، وهو عبارة عن شيءٍ في القلب يثلج له الصدر، ولا يقوى صاحبُه عن التعبير عن سببه، وله أساس من العلم والفهم، ولهذا (يعرفه) ويدركه (الإمام المحدث) فقط؛ كشعبة، وابن المديني، والإمام أحمد، والدارقطني،والبخاري ومسلم، وابن حجر، وغيرهم - رحمهم الله أجمعين - ومن المتأخرين مجدد علم الحديث في عصره الإمام الألباني - رحمه الله وقدس الله سره - ومما يدل على أن الإمام الألباني - رحمه الله - كان ملهمًا في كشفِه لعلل الحديث تضعيفه لحديث: ((اتَّقوا البول؛ فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر))، وقد تقدَّم الكلام عليه في: "باب أقسام الحديث من حيث ورود العلة الظاهرة والخفية عليه"، وخلاصته أن في إسناد هذا الحديث رجلاً مبهمًا عند ابن أبي عاصم في الأوائل [رقم 93]، وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون، كذا نقل عنهما الألباني، ثم قال: "في قوليهما إشعار لطيف بأن إسناده لا يخلو من ضعف، ولا سيما قول الهيثمي: رجاله موثوقون؛ فإنه لا يقول هذا عادة إلا فيمَن كان فيه توثيق غير معتبر".
ثم ذكر الألباني تصحيحَ كلٍّ من السيوطي والمناوي لهذا الحديث، مع أنه - رحمه الله - لم يكن قد وقف على الإسناد الذي عند الطبراني، فقد قال: "ومن المؤسف أن الجزء الذي فيه مسند أبي أمامة من المعجم الكبير ليس في المكتبة الظاهرية - عمرها الله تعالى - ولذلك فإنني غير مطمئن لتحسين السيوطي، فضلاً عن تصحيح المناوي له، ولا سيما مع كشف إسناد ابن أبي عاصم عن علته، والله أعلم".
قلت: فهنا الإمام الألباني - رحمه الله - برغم تصحيح بعض الأئمة لهذا الحديث على تفاوت أقوالهم، وبرغم عدم وقوفه على الطريق الذي اعتمدوا عليه في التصحيح، لم يطمئنَّ قلبُه لتصحيحهم، وصرح جازمًا بضعف الحديث لسببين، هما:
• أن الإسناد عند ابن أبي عاصم معلول بالإبهام؛ ففيه رجل لم يسمَّ.
• أن عبارات كل من المنذري والهيثمي توحي بضعف في الحديث؛ اعتبارًا لعادتهما في الحكم على الأحاديث.
وعند التأمل نجد أن هذين السببين غيرُ كافيينِ للجزم بضعف الحديث، حتى ينظر في الطريق التي عند الطبراني، لكن جزم الألباني بالضعف، وعدم اطمئنانه لصحة الحديث كان حتى قبل الوقوف على الإسناد الذي في المعجم، وهذا هو الإلهام عينُه الذي تحدَّث عنه النقاد الجهابذة، فعلَّة الحديث تكون راسخة في نفوسهم لأسبابٍ علمية تمتزجُ في نفوسهم بيقين يثلج له الصدر، ويطمئنُّ له القلب، فلا يقدرون على إظهار ما في نفوسهم من الدليل على وجود العلة، إلا بالتعبير عن عدم الاطمئنان لصحة الحديث، وفي مثال الألباني هذا لا أجزم أنه - رحمه الله - اعتمد في التضعيف على مجرد السببين الذين ذكرتهما، فقد ينضم إلى ذلك قرائن أخرى؛ كسبره لعادة ومنهج كلٍّ من المناوي والسيوطي في الحكم على الأسانيد مثلاً، ونحو ذلك، ففي النهاية لا نجد الألباني - رحمه الله - أقام الدليل الدامغ على ضعف الحديث إلا بعد طباعة معجم الطبراني الكبير، كما ذكر هو نفسه ذلك، فبعد أن ناقش الإسناد عند الطبراني، قال: "وبهذا تبيَّن خطأ قول المنذري والهيثمي المتقدِّم، بله ميل المناوي إلى تصحيحه، فقد تبين أن الرجل الذي لم يسمَّ... إلخ".
قلت فقوله: "وبهذا تبين"، يوحي بأن حكمه قبل وقوفه على إسناد الطبراني كان في عمومه عاريًا عن الحجة المقنعة لغيره، وكان الألباني - رحمه الله - في ذلك هو الحجة نفسه؛ لأنه لا يصحح ويضعف بهواه؛ وإنما بما علَّمه الله من أسرار هذا العلم ودقائقه، سواء كان باستطاعته إظهار البيان والحجة، أم تعذر ذلك.
ومن أشبه ما وقفت عليه من عبارات الأئمة بعبارة الشيخ الألباني - رحمه الله - قولُ أبي حاتم بعد أن ذكر علة حديثٍ: "وأول ما رأيت حديث ابن عبدالحكم استغربناه، ثم تبيَّن لي علته"[1]، وهكذا أئمة الحديث من النقَّاد حجة في الحكم على الحديث بالعلة؛ فإنهم إنما يعلون بالعلم وسَعَة الاطلاع، والتجربة والتمرس، لا بالهوى، والإلهامُ الذي يجدونه في صدورهم هو انفعالٌ نفسي مع دقائق العلل التي يرمقونها ويفهمونها في الحديث، وهو حق وَرِثوه من علم النبوة؛ فإنهم لما وَرِثُوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العلمَ، وحَفِظوا أقواله، واتصلت بها أنفاسهم، وجَرَت بها كما جرت بنفسه - صلى الله عليه وسلم - وفقهوا وعمِلوا بما علِموا متَّبعين سنته، ناصرين لها، حافظين غير مبدلين، كان لهم الحظ الأوفر من علوم النبوة، ومنها هذا الإلهام الذي يعرفون به السقيمَ من الصحيح من الأحاديث والأخبار، وليس إلهامهم هذا ضربًا من شطحات الصوفية وضلالاتهم ممن يقولون: (حدثني قلبي عن ربي)، أو زيغ المدارس الفلسفية الذين يمجِّدون العقل ويدَّعون به كشف المحجوب؛ وإنما الإلهام الذي يقف به أهل الحديث على علل الحديث هو نعمة من الله ومنَّة؛ إذ هو يقين نفسي مبني على الوقوف على الحديث، ثم إدراك أمور في رواته أو لفظه أو فيهما، تجعلهم يحكمون على الحديث بوجود علة فيه، حتى وإن لم يجدوا البرهان الذي يظهرونه لغيرهم.
وقد سئل أبو حاتم عن حديث أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعًا: ((مَن صلى اثنتي عشرة ركعة، بُنِي له بيت في الجنة))، فقال: "هذا خطأ، الناس يقولون عن أم حبيبة، قلت لأبي: الخطأ ممن هو؟ قال: لا أدري"[2].
وقال الحاكم في حديثٍ: "هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات، وهو إسناد باطل من حديث مالك، ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو؟ فلم أقفْ عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري، على أنه صدوق مقبول"[3].
وسأل ابن أبي حاتم ابنَ خالته "أبا زرعة الرازي عن حديثٍ رواه بقيَّة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسًا، فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر، فقال أبو حاتم: تعرف له علة؟ قال: لا"[4].
وما يؤكِّد هذا هو القصة التي ذكرها ابن أبي حاتم: "جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي مِنْ أهلِ الفهم منهم، ومعه دفترٌ فعرضه عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأ، قد دَخَل لصاحبه حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطل، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضهِ: هذا حديثٌ كذب، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاح، فقال: من أين علمتَ أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟! أخبَرَك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ، وأني كذبتُ في حديث كذا؟ فقلتُ: لا؛ ما أدري هذا الجزء من رواية مَنْ هو؟ غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: تدَّعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عمَّا قلتُ مَن يُحسِن مثل ما أُحسِن؛ فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازفْ ولم نَقُلْه إلا بفهمٍ، قال: مَن هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتَ؟ قلت: نعم، قال: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغَدٍ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليَّ، وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث؛ فما قلت: إنه باطل، قال أبو زرعة: هو كذب، قلتُ: الكذب والباطل واحد، وما قلت: إنه كذب، قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت: إنه منكر، قال: هو منكر، كما قلتُ، وما قلت: إنه صحاح، قال أبو زرعة: هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟! فقلت: فقد علمت أنَّا لم نجازف؛ وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله أن دينارًا نَبَهْرَجًا يُحمَل إلى الناقد، فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فإن قيل له: مِن أين قلت: إن هذا نبهرج؛ هل كنت حاضرًا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا، فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمِن أين قلتَ: إن هذا نبهرج؟ قال: علمًا رُزقت، وكذلك نحن رُزقنا معرفة ذلك، قلتُ له: فتحمل فصَّ ياقوت إلى واحدٍ من البصراء من الجوهريين، فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج، وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا، قال: فمِن أين علمت؟ قال: هذا علم رُزقت، وكذلك نحن رزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب، وهذا حديث منكر، إلا بما نعرفه"[5].
وقد عبَّر الإمام ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك بقوله: "وقد تقصر عبارة المعلِّل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم"[6]، وقال ابن كثير - رحمه الله -: "حتى قال بعض حفَّاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل"[7]، وأدقُّ مَن عبر عن ذلك ابن مهدي والسخاوي، قال ابن مهدي: "هي إلهام لو قلت للقيِّم بالعلل: من أين لك هذا؟ لم تكن له حجة؛ يعني: يعبِّر بها غالبًا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع"، قال السخاوي عقبه: "وهو كما قال غيره: أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم ردُّه، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها"[8].
وهؤلاء الأئمة المُلْهَمون هم أعرف الناس بالله، وأكثرهم التزامًا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنهج صحابته، وأدقهم فهمًا، وأجلهم علمًا، وهم صفوة الله من خلقه، ونخبة النخبة من أوليائه، وسادة أهل الحديث والأثر، وما سلك سبيلَهم سالكٌ إلا آتاه الله مما آتاهم، وناله من الخير الذي نالوه، ومن إرثهم الذي ورثوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا الإلهام جزء لا يتجزأ من نصيب الورثة، الذين استوفوا شروط الإرث، وجانبوا موانعه، فاستحقوا بفضل الله وعنايته النصيبَ المفروض، جعلنا وإياكم مِن ورثة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - ومن أصحابه وأتباعه وأحبابه في الدنيا والآخرة، ومن الفائزين بجنةٍ عرضُها السموات والأرض، آمين.
(لكن إذا خولف) الإمام في حكمه على الحديث بالعلة، وذلك إذا نفى إمام آخر هذه العلة، وقد ظهرت الحجج التي تثبت ذلك، (فالترجيح) بين أقوال الأئمة بتطبيق قواعد الجرح والتعديل، هو المتوجه إليه، الذي (عليه الاعتماد)؛ وذلك بتمييز أقوالهم، والنظر في أوجُه التعارض وصوره، (والتنقيح) بينها لاستخلاص الحكم الصواب.
فإن أعلَّ إمامٌ من الأئمة حديثًا، ولم يكن له مخالف في الحكم، قُبِل منه إعلاله، وإن لم يظهر عليه الحجة؛ لأنه حجَّة بنفسه، فكما يُقبَل منه التصحيح، فكذلك يُقبَل التضعيف، ما لم يخالف الأصولَ المتفَق عليها.
وإن أعلَّ الحديث وخالفه إمامٌ ناقد، فيصار إلى الترجيح بين الأقوال المتعارضة بحسب قواعد الجرح والتعديل، (ومثله إن لم يرجح) الإمامُ الذي أعلَّ الحديث، فلم يذكر العلة ولم يرجحها؛ (و) إنما (اكتفى بذكرها إشارة)، فذكر عدم اطمئنانه، أو نحو ذلك بحسب مراد الأئمة من ألفاظهم وعباراتهم، (وعرفَ) بذلك معبرًا عنه بعبارة تبيِّن ذلك، فهذا أيضًا يصار فيه إلى الترجيح بين الأئمة إذا وُجد التعارض، والله الموفِّق، والله - تعالى - أعلم.
===================
1] العلل؛ لابن أبي حاتم (1/409).
[2] العلل؛ لابن أبي حاتم (1/135).
[3] معرفة علوم الحديث ص 60.
[4] العلل؛ لابن أبي حاتم (1/488).
[5] مقدمة الجرح والتعديل ص349 - 351.
[6] نزهة النظر ص 84.
[7] الباعث الحثيث ص 63.
[8] فتح المغيث (1/ 230).